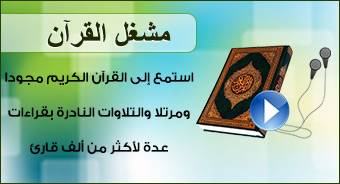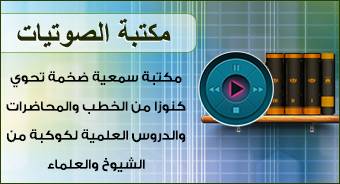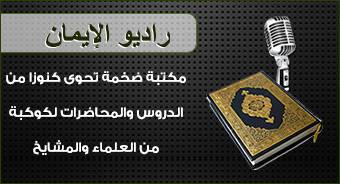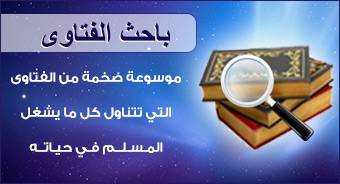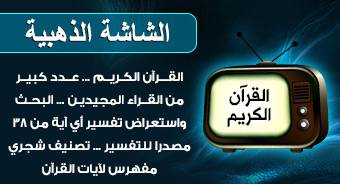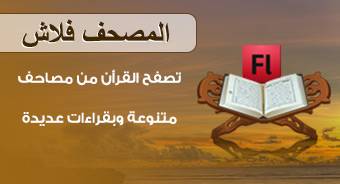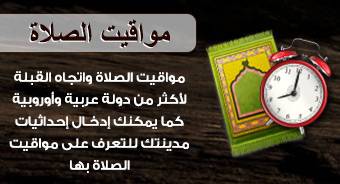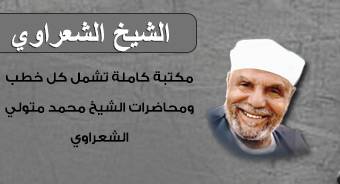|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البيان في مذهب الإمام الشافعي
دليلنا: أنها مؤنة للتخليص والتصفية، فكانت على رب المال، كمؤنة تصفية الطعام. إذا ثبت هذا: فإذا دفع رب المال زكاة المعدن إلى الساعي قبل تخليصه.. وجب رده على رب المال؛ لأن تخليصه عليه. فإن كان باقيًا.. وجب رده. فإن اختلفا في المردود، فقال رب المال: ليس هذا الذي دفعته إليك، وقال الساعي: بل هو الذي دفعته إلي، أو اختلفا في قدره.. فالقول قول الساعي مع يمينه؛ لأنه أمينٌ، فإن ميزه الساعي.. فإن القدر الذي يحصل منه يجزئ في الزكاة، فإن كان أقل مما يجب عليه.. لزم رب المال دفع التمام، ولا شيء للساعي بعمله؛ لأنه متطوع به. وإن كان المأخوذ تالفًا.. وجب على الساعي قيمته، كما إذا قبض شيئًا بالسوم، فتلف في يده.. وجبت عليه قيمته، فإن كان المدفوع تراب ذهبٍ.. قومه بفضة، وإن كان تراب فضة.. قومه بذهبٍ؛ لئلا يؤدي إلى الربا، فإن اختلفا في قدر القيمة.. فالقول قول الساعي مع يمينه؛ لأنه غارمٌ، ولأنه أمينٌ.
دليلنا: أن المقصود مستورٌ بما لا مصلحة له فيه، فلم يجز بيعه، كتراب الصاغة الذي فيه برادة الذهب والفضة، وقد وافقنا مالكٌ على ذلك. قال أبو إسحاق: وأما إذا باع ترابًا بعد أن ميز، وأُخذ منه الذهب والفضة، ثم وجد فيه فتاتٌ يسيرٌ.. جاز ذلك؛ لأن المقصود منه نفس التراب دون ما فيه، فجاز بيعه.
وقال أبو حنيفة: (هو بالخيار: بين أن يكتمه ولا شيء عليه، وبين أن يظهره ويخرج منه الخمس). دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس»، وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عن رجل وجد كنزًا في خربة؟ فقال: إن وجدته في قرية مسكونة، أو في طريقٍ ميتاءٍ.. فعرفه حولًا كاملًا، وإن وجدته في خربة جاهلية، أو في قرية غير مسكونة.. ففيه وفي الركاز الخمس».
وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنه زكاة، فلم تجب على الذمي، كسائر الزكوات. وإن وجدت المرأة أو الصبي ركازًا.. كان لهما. وقال الثوري: لا يكون لهما. دليلنا: أنهما يملكان بجميع أسباب التمليك، فملكا الركاز بالوجود، كالرجل البالغ.
فإن وجده في موضع لم يملك، وهو الموات الذي لم يحيه أحدٌ قط.. فهو ركازٌ، ولا فرق في ذلك بين موات دار الإسلام أو موات دار أهل العهد، أو موات دار أهل الحرب. وقال أبو حنيفة: (إن وجده في موات دار الإسلام، أو موات دار أهل العهد.. فهو ركازٌ يجب فيه الخمس، وإن وجده في موات دار أهل الحرب.. ملكه غنيمة له، ولا يخمس). وقال مالكٌ: (يكون بين الجيش). وقال الأوزاعي: (يؤخذ خمسه، والباقي بين الجيش). دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس». ولم يفرق بين موات دار الإسلام وغيرها. وإن وجده في موضع قد ملك.. نظرت: فإن لم يعرف مالكه، مثل: مواضع عادٍ وقومه.. فالحكم فيه كالحكم فيما وجد في مواتٍ؛ لأن ما لا يعرف مالكه بمنزلة ما لم يملك. وإن وجده في أرض عرف مالكها، فإن كانت في دار الإسلام، أو في دار أهل العهد.. لم يكن ركازًا، ولا يملكه، بل يحفظه إلى أن يجد صاحبه، فإن جاء.. أعطاه، وإلا كان لبيت المال؛ لأنه مالٌ محرزٌ في ملكه، والظاهر: أن صاحبه أحرزه. وإن كان في دار الحرب.. فإنه يكون غنيمة، وبه قال أبو حنيفة. وقال أبو ثورٍ، وأبو يوسف: (ينفرد به الواجد). دليلنا: أنا حكمنا بأن الموضع ملكٌ للمشركين، فالظاهر: أن ما كان فيه، فهو لهم. وإن وجد الرجل في داره أو أرضه ركازًا، فإن قال: هو لي كنت دفنته.. قبل قوله من غير يمينٍ؛ لأن الظاهر أنه له، وإن قال: ليس لي.. قال الشافعي: (فالظاهر أنه ملكٌ لمن أخذ منه تلك الدار). فإن ورثها من أبيه.. قسم المال بين جميع ورثة الأب، إن ادعوا ذلك، وإن ادعاه بعضهم دون بعضٍ.. دفع إلى من ادعاه نصيبه، ووقف نصيب من لم يدعه. وإن قالوا: ليس بملكٍ لأبينا.. فالظاهر: أنه لمن انتقل منه الدار إلى الأب. فإن لم يدعه أحدٌ ممن ملك هذه الدار.. قال ابن الصباغ: كان ذلك لقطة. وإن اكترى من رجلٍ دارًا، فوجد فيها ركازًا، فادعى كل واحدٍ منهما: أنه له.. قال الشافعي: (فالقول قول المكتري). وقال المزني: القول قول المكري، وهذا خطأٌ؛ لأن يد المكتري على الدار وما فيها، فكان القول قوله فيما في يده. ولا يحكم بأنه ركازٌ إلا بأن يكون من مال جاهليٍّ، يعلم أن مثله لم يضرب في الإسلام، بأن يكون عليه اسم أحدٍ من ملوك أهل الشرك أو صورة الصلبان، لأن الظاهر أنه لمشركٍ. فأما إذا كان عليه آية من كتاب الله، أو اسم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أو أحدٌ من خلفاء المسلمين.. فليس بركازٍ، بل هو لقطة يجب تعريفها.
ومن أصحابنا من قال: إنه ركازٌ، وذكر ابن الصباغ: أن هذا قولٌ للشافعي في "الأم" [2/37]؛ لأن الظاهر منه إذا كان من مواتٍ: أنه ركازٌ.
الأول: قال في الجديد: (لا تجب فيه الزكاة). وهو الصحيح؛ لأنه مقومٌ استفيد من الأرض، فلم يجب فيه شيءٌ، كما لو استخرج من المعدن. والثاني: قال في القديم: (يخمس كل ما وجد؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس». ولم يفرق). ولا يعتبر الحول فيما يؤخذ من الركاز، قولًا واحدًا، وهو قول كافة العلماء؛ لأنه مستفادٌ من الأرض، فلا يعتبر فيه الحول، كالحبوب والثمار، والفرق بينه وبين ما يؤخذ من المعدن على القول الضعيف: أن ما يؤخذ من المعدن أخذه بتعبٍ ومؤنة، فلهذا اعتبر فيه الحول، وهذا أخذه بغير تعبٍ ولا مؤنة.
الأول: قال في القديم: (لا يعتبر فيه النصاب، بل تجب الزكاة في قليله وكثيره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس». ولم يفرق)، ولأنه مال مخموس، فخمس قليله وكثيره، كالغنيمة. والثاني: قال في الجديد: (لا يجب إلا في النصاب). قال الشافعي: (ولو كنت أنا الواجد، لخمست قليله وكثيره). وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ليس فيما دون مائتي درهم شيء، وليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب شيء». ولم يفرق بين الركاز وغيره، ولأنه حق مصروف إلى أهل الصدقات، فاعتبر فيه النصاب، كسائر الزكوات. وأما الخبر الأول: فهو عام، وهذا خاص، والخاص يقدم على العام. فعلى هذا: إذا وجد دون النصاب من الذهب أو الفضة، فإن لم يكن معه شيء من جنسه.. لم يجب عليه شيء. وإن كان معه شيء من جنسه.. فلا يخلو: إما أن يكون الذي عنده نصابا أو أقل من النصاب: فإن كان الذي عنده نصابا.. نظرت: فإن وجد الركاز مع حؤول الحول على النصاب.. أخرج الخمس من الركاز، وعن النصاب ربع العشر، نص الشافعي عليه؛ لأن النصاب قد حال عليه الحول، ووجبت فيه الزكاة، والركاز لا يعتبر فيه الحول، فهو كما لو كان موجودا مع النصاب من أول الحول. وإن وجد الركاز بعد حؤول الحول على النصاب الذي عنده.. لزمه أن يخرج الخمس عن الركاز، سواء كان قد زكى النصاب الذي عنده، أو لم يزكه، نص عليه الشافعي أيضا؛ لأن ما معه قد حال عليه الحول، والركاز في حكم ما حال عليه الحول. قال ابن الصباغ: ولا خلاف بين أصحابنا في هاتين المسألتين. وإن وجد الركاز قبل حؤول الحول على النصاب الذي عنده، مثل: أن يكون عنده مائتا درهم، فأقامت عنده أحد عشر شهرًا، ثم وجد من الركاز مائة درهم.. ففيه وجهان: أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، وأبي إسحاق صاحب "المهذب" -: أنه لا يضم المائة من الركاز إلى ما عنده، بل إذا تم حول النصاب.. زكاه، وإذا تم حول المائة من حين وجدها.. أخرج عنها ربع عشرها؛ لأن النصاب الذي عنده لم يحل عليه الحول، والركاز وإن كان في حكم ما حال عليه الحول، إلا أنه كبعض نصاب حال عليه الحول، فلم تجب فيه عليه زكاة. قال الشيخ أبو حامد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وهذه ليست بمنصوصة للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -، ولكنه قد نص على مثلها، فقال: (لو استفاد مائة درهم من الركاز، وليس معه مال سواها.. فلا شيء فيها؛ لأنها دون النصاب، فإن وجد بعدها مائة درهم أخرى ركازًا.. لم يجب فيها شيء). فلم يوجب في الثانية شيئًا؛ لأن الذي معه لم يحل عليه الحول، ولا هو في حكم مال حال عليه الحول. والوجه الثاني - وهو قول القاضي أبي الطيب في " شرح المولدات "، واختيار ابن الصباغ -: أن المائة تضم إلى النصاب وإن كان قبل الحول، ويخرج الخمس عن المائة، وإذا تم حول النصاب.. أخرج عنه ربع العشر. واحتجا بنص الشافعي في المسألة قبلها، وهو إذا وجد ما دون النصاب بعد حؤول الحول على النصاب.. أنه يلزمه أن يخرج الخمس عن الركاز، وإن كان الحول الثاني لم يتم على ماله، ولا حكم للحول الذي انقضى قبل وجود الركاز، ولأن الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - قد قال: (إذا كان ماله دينًا أو غائبًا، عرف الوقت الذي أصاب فيه الركاز، فإن كان ماله الغائب في يد من وكله، أو من عليه الدين مليئًا مقرًا به.. فهو كما لو كان المال في يده ويخرج زكاة الركاز). ولم يعتبر وجوده في آخر جزء من آخر الحول أو بعده. وأما المسألة التي احتج بها الشيخ أبو حامد: فقال القاضي: أراد الشافعي: إذا وجد المائة الثانية بعد تلف الأولى، فأما إذا وجد الثانية مع بقاء الأولى.. فإنه يخرج من الثانية خمسها؛ لأن الشافعي قال فيها: (فكان كمال يفيده في وقت، فتمر عليه سنة، ثم يفيد آخر في وقت، فتمر عليه سنة، فليس فيه الزكاة). وأراد: إذا كان الأول قد خرج عن ملكه، وإلا فإذا كان باقيًا.. وجبت الزكاة في السنة الثانية. هذا إذا كان الذي عنده نصابًا، فإن كان الذي عنده أقل من نصاب، بأن كان عنده مائة درهم، ثم وجد مائة درهم من الركاز، فإن وجدها مع آخر الحول على المائة، أو بعد الحول.. ففيه ثلاثة أوجه: أحدها - وهو المنصوص، وهو قول أبي علي الطبري، والشيخ أبي حامد -: (أنه يجب في المائة التي كانت عنده ربع العشر في الحال، ويجب في المائة التي أخذها ركازًا الخمس في الحال)؛ لأن الذي عنده قد حال عليه الحول، وما وجده في حكم ما حال عليه الحول، فهو كما لو كان في يده مائتا درهم من أول الحول إلى آخره. والوجه الثاني - وهو قول القاضي أبي الطيب، واختيار ابن الصباغ -: أنه يجب في المائة المأخوذة من الركاز الخمس؛ لأنه لا يعتبر فيها الحول، وقد انضمت إلى المائة الأخرى في النصاب، ولا يجب في المائة التي كانت عنده شيء، حتى يحول عليها الحول من حين تم النصاب؛ لأن الحول لا ينعقد عليها مع نقصانها عن النصاب. والوجه الثالث: أنه لا يجب في المائتين شيء في الحال، بل يستأنف بهما الحول من حين تم النصاب، فإذا تم حولهما.. أخرج عنهما ربع العشر؛ لأن ما دون النصاب لا يجري في الحول. وإن وجد المائة قبل تمام الحول على المائة التي كانت عنده.. ففيه وجهان: أحدهما: وهو قول الشيخين: أبي حامد، وأبي إسحاق -: أنه لا يجب فيهما في الحال شيء، بل يستأنف الحول عليهما من حين تم النصاب، فإذا حال الحول عليهما.. وجب فيهما ربع العشر. والثاني - وهو قول القاضي أبي الطيب، وابن الصباغ -: أنه يجب في المائة التي وجدها من الركاز الخمس في الحال، ويستأنف الحول في المائة الثانية التي كانت عنده من حين تم النصاب، فإذا تم حولها، أخرج عنها ربع العشر.. ووجههما: ما ذكرناه في المسألة المتقدمة.
وإن قال له السيد: خذه لنفسك، فإن قلنا: يملك العبد إذا ملك.. فهو للعبد، ولا زكاة على أحدهما فيه. وإن قلنا: لا يملك.. فهو للسيد، وزكاته عليه. وقال الثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد: (إذا وجد العبد ركازًا.. أرضخ له منه). وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: (هو له بعد الخمس). دليلنا: أن كسب العبد ملك للسيد، وذلك من كسبه، فكان للسيد كالصيد. والله أعلم، وبالله التوفيق.
وقال أبو حنيفة: (هي واجبة، وليست بمفروضة)؛ لأن الواجب عنده أقل درجة من المفروض، فالمفروض: ما ثبت بالأخبار المتواترة، كالصلوات الخمس، والواجب: ما ثبت بأخبار الآحاد، مثل: الوتر عنده، وهذا خلاف في التسمية لا غير. وقال الأصم، وابن عُلية، وقوم من أهل البصرة: لا تجب زكاة الفطر. وبه قال أبو الحسين ابن اللبان الفرضي من أصحابنا. دليلنا: ما روى ابن عمر: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر على الناس في رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين». فلنا منه دليلان: أحدهما: قوله: (فرض) بمعنى: ألزم، وحتم، ولا يجوز أن يكون معناه قدر؛ لأنه قال: (على الناس) ولو كان المراد التقدير.. لقال: للناس. والثاني: أنه قال: (زكاة)، والزكاة: لا تكون إلا مفروضة لازمة..
وجملة ذلك: أن من قال من أصحابنا: إن الكفار الأصليين غير مخاطبين بالشرائع.. قال: لا تجب عليهم زكاة الفطر، واحتج بقول الشافعي هاهنا: (إلا على المسلمين). ومن قال من أصحابنا: إن الكفار الأصليين مخاطبون بالشرائع.. قال زكاة الفطر واجبة عليهم. ونقول: معنى قوله: (إلا على المسلمين)، أي: فرض الأداء. وإن كان الكافر مرتدًا.. فعلى ما ذكرناه من الأقوال الثلاثة في أول الزكاة. وأمَّا المكاتب: فالمنصوص للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في عامة كتبه: (أنه لا تجب زكاة فطرته في ماله ولا على سيده). وبه قال ابن عمر، وأبو حنيفة. وروى أبو ثور، عن الشافعي: (أن زكاة فطره تجب على سيده). وبه قال عطاء، ومالك رحمة الله عليهما، وقال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (تجب في كسبه). وحكاه في "المهذب" وجهًا عن بعض أصحابنا. دليلنا: أن المكاتب ناقص الملك، بدليل: أنه لا تجب عليه زكاة المال، فلم تجب عليه زكاة الفطر؛ كالذمي، والدليل على أنها لا تجب على سيده: أنه معه كالأجنبي، ولهذا يصح البيع بينهما.
وقال أبو حنيفة: (لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الورق أو ما قيمته نصاب) دليلنا: ما روى ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وأرضاهما: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد، ذكر وأنثى». ولم يفرق بين أن يكون واجدا للنصاب أو غير واجد. وإن فضل معه نصف صاع.. ففيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه إخراجه، كما لو وجبت عليه رقبة، فلم يجد إلا نصفها. والثاني: يلزمه، وهو الصحيح؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا أمرتكم بأمر.. فأتوا منه ما استطعتم». ولأنه لو ملك نصف عبد.. للزمه نصف فطرته، فكذلك إذا ملك نصف صاع.. لزمه إخراجه. وإن كان معسرا حال الوجوب، ثم أيسر بعد ذلك.. لم يلزمه الإخراج، بل يستحب له. وقال مالك رحمة الله عليه: (يلزمه الإخراج إذا أيسر يوم الفطر). دليلنا: أنه لم يكن موسرا وقت الوجوب، فلم يلزمه إذا أيسر بعد ذلك، كما لو أيسر بعد يوم الفطر.
وإن كان الابن صغيرًا موسرًا.. فنفقته وفطرته في ماله، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف. وقال محمد بن الحسن: نفقته في ماله، وفطرته على أبيه. دليلنا: أن نفقته في ماله، فكانت فطرته في ماله، كالأب. وأما إذا كان له ابن ابن، أو ابن بنت صغير معسر.. لزم الجد نفقته وفطرته. وقال أبو حنيفة: (لا يلزمه). دليلنا: أنه يطلق عليه اسم الولد.. فلزم الجد نفقته وفطرته، كولده الصغير من صلبه. وأما الآباء والأجداد والأمهات والجدات: فمن كان منهم فقيرًا زمنًا.. فإن نفقته وفطرته على ابنه، أو ابن ابنه وإن سفل، وإن كان معسرًا صحيحا.. فهل تجب نفقته وفطرته على ابنه؟ فيه طريقان، حكاهما ابن الصباغ: أحدهما: أنها على قولين. والثاني: لا يلزمه، قولًا واحدًا، ويأتي توجيه ذلك في (النفقات). وأما الولد الكبير: فإن كان معسرًا زمنًا.. وجبت نفقته وفطرته على الأب أيضًا، وإن كان معسرًا صحيحا.. بني على الأقوال في وجوبها على الأب الصحيح: فإن قلنا: لا تجب نفقته وفطرته، قولًا واحدًا.. فالابن البالغ الصحيح أولى أن لا تجب نفقته ولا فطرته. وإن قلنا: في الأب قولان.. ففي الولد البالغ الصحيح طريقان: أحدهما: أنها على قولين. والثاني: لا تجب، قولًا واحدًا. هذا مذهبنا. وقال أبو حنيفة: (لا يجب عليه فطرة من لا ولاية له عليه، فلا تجب على الأولاد فطرة الوالدين، ولا تجب على الأب فطرة الابن البالغ بحال). دليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ممن تمونون». ولم يفرق، وروي عن علي كرم الله وجهه: أنه قال: (من جرت عليك نفقته، فأطعم عنه نصف صاع، من بر، أو صاعًا من تمر أو شعير). ولا يعرف له مخالف. فإن كان للوالد أو الولد عبد يحتاج إليه للخدمة.. وجبت نفقته وفطرته على من وجبت عليه نفقة مولاه وفطرته؛ لأنه تابع له. وإن كان مستغنيًا عن خدمته.. كانت نفقة مولاه وزكاة فطرهما في قيمته، فيباع منه بقدر ذلك، فإن تعذر بيع جزء منه.. بيع جميعه.
أحدهما: يلزمه كما يلزمه نفقتها. والثاني: لا يلزمه، كما لا يلزم الأب. والأول أصح. وإن كان له ابن تلزمه نفقته، وللابن زوجة.. لم يلزم الأب فطرة الزوجة، كما لا يلزمه نفقتها. |